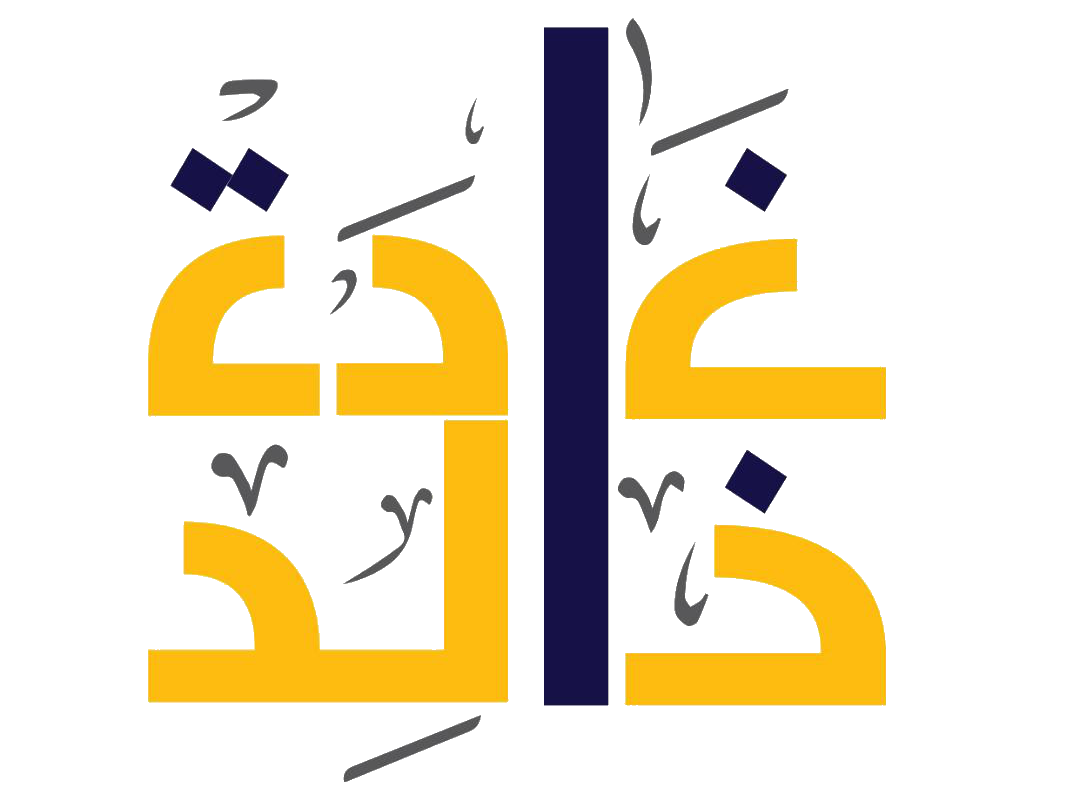تِنتِن، اسمها الحقيقي فاطمة و هي صديقة عزيزة لأمي وتزاملتا منذ أيام الجامعة و فرقت بينهما الأيام منذ اوائل الثمانينات. و بالرغم من البعاد إلا أن أمي ما فتئت تذكر صديقتها بين حين و آخر, ونشأت على سيرتها حتى صرت أفكر في تنتن كشخصية خيالية أو مجرد أسطورة كسندريلا و ذات الرداء الأحمر, حتى أتى اليوم الذي إلتقيتها فيه مصادفة و أتضح لي إنها شخصية حقيقة من لحم و دم. كانت دوما ما تقول لي أمي أن أجمل القصص التي سمعتها منها مما حكته لها فاطمة ذات يوم. و في أحد المرات قصت عليها فاطمة عن عادات في منطقة ما من مناطق السودان. فما أن تضع ربة المنزل الأكل في الصينية, تقف (و لا تجلس) أمام الضيف, و تبدأ (الخسيم)
ما أكلتي، أكلى-
الرسول، يجافيك، إبدا المسخة فيك –
و تواصل سيدة المنزل (الخسيم)
يباردك المصطفى، يمرقك من الصف-
يدرشك, يسوي ليك حلقة (مرض جلدي) تكرشك-
و ظلت تنتن حضورا على خاطري كلما أتعرض لموقف فيه (خسيم) و إصرار ثم (حلفان). زرت صديقتي بعد خروجها من المستشفى و بيدها طفل صغير. وكانت والدتها الحاجة حضرت من السودان للمشاركة في عملية الترحيب بأول حفيد. و بدأت رحلة العزائم و (الخسيم)،الحاجة
– عليك الله أشربي!
-ما كملتي!
-أجيب ليك حاجة تانية؟
– عليك الله, عليك الله! و نظرت صوب صديقتي بحيرة فبادرتني مبتسمة
-ما تستغربي, إحنا المعاها في البيت بتخسمنا.
وذكر أحد الأصدقاء ذهابه إلى عزاء مع جدته. و بعد خروجهما علم أنها جائعة و تعبة جدا, فسألها مندهشا
– نحن ختوا لينا الغذاء, إنتوما ختو ليكم الأكل؟
أجابت الجدة حفيدها بنعم, فسألها محتارا
– “طيب ليه ما أكلتي؟”
فاجابته و الجدية تبدو على قسماتها:
-ما خسموني
و لا أدري من أين أتت ثقافة (الخسيم) تلك, و إصرارنا عليها ضيوفاً أو مضيفين. حتى صارت الأساس و نقطة الإنطلاق نحو ما يقدم إلينا من أكل أو شراب. إبان إقامتنا بالقاهرة حضرت إحدي الأسر من الولايات المتحدة الامريكية لتستقر بجمهورية مصر العربية فترة من الزمن حتى يتعلم فيها ابناؤها اللغة العربية بعدما صارت دخيلة عليهم بسبب ولادتهم و نشأتهم بامريكا. و ذهبنا لزيارة تلك الأسرة و إبداء مشاعر المودة تجاهها و لا سيما أن لديهم إبنة تقاربني وأختي في العمر. جلسنا أنا وأختي وبنت أمريكا في غرفتها نتحدث بعربية ركيكة من جانبها “إنته واحد مش بيقعد كويس” وإنجليزية “دونكي مي رايد يو” من جانبنا. و بدينا كما وقد اتصل بيننا حوار (الطرشان). و بعد لحظات مثيرة و مليئة بالضحكات على الموقف العجيب جاءت الفتاة تحمل (صينية) الشاي فوضعتها قبالتنا صبت الشاي من البراد و مدت لنا أكوابه مخلوطا باللبن في أكواب صغيرة من ذوات الأذن الصغيرة.. و تناقلت الأكواب أيدينا و ألسنتنا تتمتم بكلمات الشكر لها, و ظلت صناديق (البسكويت) الصغيرة طريحة الصينية أمامي أنا وأختي تنظر إلينا و ننظر لها و لا نمتلك الجرأة على تناولها. و لربما شعرت الفتاة (الامريكية) السودانية بتلك الخواطر, فإلتقطت الصندوقين ومدتهما لنا بصورة عملية ونهائية. فارتبكنا. وامتنعنا عن أخذهما بطريقة إمتناعية تقليدية.
فما كان من بت أمريكا إلا أن هزت كتفيها بلا مبالاة وقالت: “أوه، يو دونت وانت إت” ووأعادت وضع صندوقي البسكويت حيث كانا بالصينية. و بدأنا أنا و أختي في إسترقاق النظر إلى بعضنا البعض و نتحكم في ضحكات ستجلجل إذا أطلقنا سراحها. “منو القال ليك ما عايزين البسكويت؟ هو في زول يابا البسكويت مع شاي اللبن؟ إنتو الخسيم ما درسوكم ليهو؟” ولم نرفع أعيننا عن قطع البسكوت العائدة إلى مواقعها بأمان بين الأكواب و (السكرية) و براد الشاي. و خرجنا من منزل الاصدقاء و انا أمسك بيد اختي بما يشبه التضامن على الصبر على سخرية الموقف حتى تيقنا من اننا إبتعدنا و وانفجرنا بالضحك. لم نعرف يومها كيف فلت منا ذلك البسكويت بين امتناع البت الأمريكية عن الخسيم وخشيتنا أن لا نمد ايدينا إليه وأخذه في محاولة لإصلاح خطأنا. فالفتاة بالرغم من سودانيتها إلا انها امريكية النشأة و الطباع و لا أظنها كانت ستعبأ بأن إلتقطنا تلك القطع أو تركناها و لكنه طبع صار بداخلنا إلا نمد أيدينا على الشيئ حتى ندعو له بإلحاف. وخرجنا من المولد بغير بسكويت مثل جدة صديقي. وكلنا كالعير يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول.
وغدا إذا مددت لي إكراماً يوما بالله خسمني . . بلا زعل.