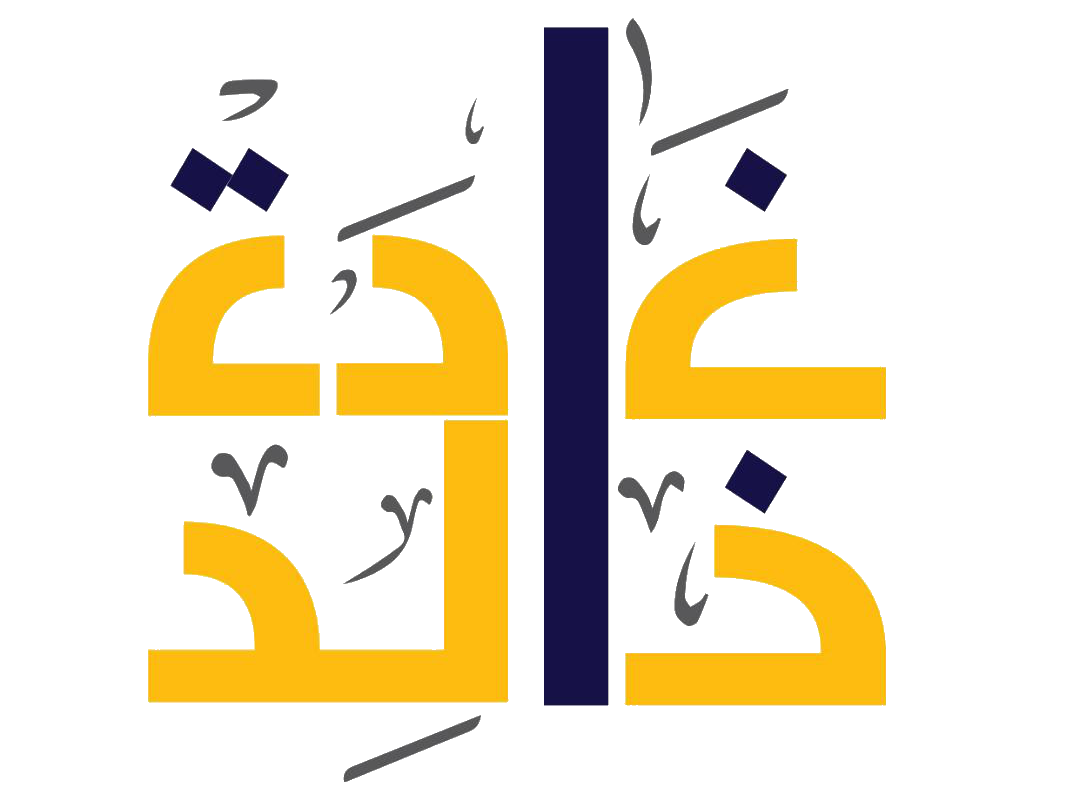رزنامة الأسبوع 15-21 مايو 2007
الثلاثاء :
وبدأ العام الجديد. البرد قارس. الجليد يتساقط ، نديفاً أول أمره ، ثم ما يلبث أن يتهاوى كثيفاً على الرؤوس والأكتاف. أغلبه يسقط فوق أسقف البنايات ، وسطوح المركبات ، قبل أن يغطي الأرض ، يحيل لونها إلى أبيض ناصع ، ويوارى سواد أسفلت الشوارع الذي يندس تحته.
(ويسلى اوترى) يهتف بابنتيه الصغيرتين أن تسرعا. ينزلون درجات السلم قفزاً لئلا يفوتهم قطار الأنفاق الذي سيحملهم إلى حيث الدفء الحقيقي في البيت ، فالجاكيتات والمعاطف في برد نيويورك لا تدفئ ، مهما ثَقلت.
وصل (ويسلى) وطفلتاه إلى الرصيف ، ووقفوا ينتظرون القطار كما تعوَّدوا أن يفعلوا كل يوم. فجأة ، أبصروا شاباً صغيراً لم يتجاوز التاسعة عشر يترنح. يجهد ليمسك بعمود إلى جانبه ، لكنه ما يزال يترنح. أنوار قطار الأنفاق بدأت تظهر ، وصوت صفارته بدأ يعلو ويعلو ، وجسد الشاب ما زال يترنح ويترنح أكثر فأكثر. كان واضحاً أنه بدأ يفقد وعيه وتوازنه. و .. في ثانيةٍ زلت قدماه. سقط على القضبان أمام القطار القادم منطلقاً بعيونه المُشعَّة ، وصفارته المتعالية ، تماماً مثل وحش كاسر. رأى الجميع المنظر لينفجر الصراخ!
في جزء من الثانية التالية ، نفض (ويسلي) يدى ابنتيه الصغيرتين ، وقفز خلف الشاب ليستقر إلى جواره على القضبان. لم يعُد يفصل بينهما وبين الوحش المندفع بأقصى قوَّته غير ثوان معدودات. إستحال صراخ الجموع إلى شئ كالهستيريا. بدأ البعض يلوح للسائق ، لكن كان واضحاً أنه لن يتمكن من التوقف قبل أن يبلغ مكان الرجلين. أيقن الجميع من أنه سيدهسهما لا محالة. أسرعت سيدة متوسطة العمر تدفع الطفلتين بعيداً عن الرصيف لتجنبهما رؤية القطار وهو يمزق جسد والدهما!
ما بين غمضة عين وانتباهتها كان القطار ـ الوحش يمُرُّ ، بهدير يصُمُّ الآذان ، فوق الرجلين ، ويتعداهما بثلثيه ، قبل أن يتوقف مُخفياً الرجلين تحته بالثلث المتبقي! ساد الهرج والمرج. البعض انخرط في عويل جنوني ، والبعض الآخر أفقدته الصدمة النطق ، فتجمَّد مذهولاً. إكتظت المحطة فجأة بقوات الشرطة وعربات الاسعاف. وأخذ الجميع يتدافعون لإخراج ما قد يكون التصق بالقضبان والعجلات من مِزَق لحم الرجلين وشظايا عظامهما! لكن ، وفي ما يشبه المعجزة ، ووسط دهشة الجمهور الذي ألجمته المفاجأة ، خرج (ويسلي) سليماً معافى ، بل وساعد في إخراج الشاب الصغير الذي كان قد أصيب ببعض الجروح فنقل من فوره إلى المستشفى ، حيث أجريت له بعض الاسعافات!
وكما تسري النار في الهشيم ، تناقل الناس في نيويورك ، خلال الأيام التالية ، خبر (كامرون هوليبتر) ، الطالب بأكاديمية السينما بالمدينة ، والذي كان في انتظار القطار عندما أغمي عليه ، ثم لم يدر بما حدث له بعد ذلك ، أو كيف أنقذه (ويسلي) ، إلا بعد أن أفاق بالمستشفى! أما (ويسلي) نفسه فقد تحول إلى بطل ، ولم يعُد للناس من شغل سوى اجترار مأثرته في كل مكان. وأصبح ، بين ليلة وضحاها ، نجماً كثيف الحضور في أكثر من قناة ، تتبارى كاميرات التلفزيون لتفوز بشريط له ، ويتنافس أكبر المذيعين ومقدمي البرامج على تصريحاته وأحاديثه. وكان مما قال بعد الحادثة ، وببساطة آسرة:
ـ “لا أعرف لماذا الجميع مندهشون ، فأنا لا أشعر بأنني فعلت شيئاً غير عادى! لقد كان ثمة شخص يحتاج مساعدتي ، وقد قدمتها له! لقد كان قراراً سريعاً لم يأخذ مني وقتاً. إن عملي في مجال البناء أكسبني خبرة واسعة في سرعة تقدير الأمور. لذا ، وعندما رأيت (كامرون) يهوى على القضبان قفزت خلفه آملاً في إخراجه قبل وصول القطار! لكن ، وعندما أدركت أن الوقت لن يتسع لذلك ، قررت أن أحمي جسد كامرون بجسدي ، وبقيت مُخفِضاً رأسي والقطار يمر من فوقي وكامرون تحتي ، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من مفارم القطار. وقد وجدت أن بعضاً من زيت القطار قد تساقط على قبعتي”!
لم يكتف (ويسلى) بذلك ، بل ذهب إلى المستشفى ليزور (كامرون) ، حيث التقى بأسرته التي كان لسانها يلهج بالشكر له. وأثنى والد (كامرون) عليه قائلاً إنه لولا ما أبدى من شجاعة منقطعة النظير ، لكان ابنه في خبر كان! وعلى مدى أيام طوال ظل (ويسلي) يتلقى آلاف المحادثات والرسائل. وتقديراً لإنسانيته وبسالته نفحه الثرى الأمريكي (دونالد ترامب) خمسة آلاف دولار ، كما تلقى مثلهم من مدير أكاديمية السينما التي يدرس فيها (كامرون). كذلك حصل (ويسلي) على كمبيوتر جديد لبنتيه ، وإجازة مدفوعة التكاليف له ولأسرته ليستمتعوا بزيارة حدائق والت ديزنى العالمية ، و كرَّمه عمدة نيويورك بأن قلده ميدالية برونزية هي أعلى ما يُمنح للمواطنين على قيامهم بأعمال بطولية ، أو تحقيقهم لإنجازات عالية. بل ، وفوق ذلك كله ، تمت استضافته من جانب الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في مناسبة الخطاب السنوي التقليدي للرئيس ، وشكره على مسمع ومرأى من العالم أجمع. هذا بالإضافة إلى عربة ، وتأمين مدفوع عليها لمدة عام ، والكثير ، إلى ذلك ، من الهدايا والجوائز.
بقدر ما تغيرت حياة (ويسلي) بسبب قراره ، الذي لم يأخذ التفكير فيه من وقته الكثير ، بالمخاطرة بحياته وأسرته من أجل شاب لم يره ، ولا مرة واحدة ، من قبل ، وتدخله السريع لإنقاذه من موت محقق تحت عجلات قطار مسرع ، بقدر ما عزز الثقة ، وسط كل الاعتبارات العرقية والطبقية ، في طيبة قلب الانسان ، من حيث هو إنسان ، و .. هل فاتني أن أخبركم بأن (ويسلي) أمريكي أسود ، بينما (كامرون) أمريكي أبيض؟
الأربعاء :
ظللت ، طوال صباي المدرسي ، أمنى نفسي بحياة جامعية ثرية ، وأحلم بالمحاضرات الممتعة ، والحدائق الوريفة ، والقاعات المهيبة ، والمكتبات العامرة ، والصداقات الناضجة ، وأركان النقاش الساخنة ، ومجموعات الدراسة والبحث ، وساحات النشاط الذي لا يهدأ ، و .. تلك الشنطة ، شنطة اليد الحمراء الجميلة التي كانت قد أعجبتني يوماً في صغرى ، ووعدني أبى بها عندما أدخل الجامعة ، فصارت حلمي الدائم. لكن القدر كان أسرع ، فهجرنا السودان لأسباب معلومة.
إنتقلنا إلى القاهرة ، حيث رحت أزحف من سنة دراسية إلى أخرى. أكملت المرحلة المتوسطة ، فالثانوية ، ثم جلست لامتحانات الشهادة ، ونجحت. ولم تعُد تفصل بيني وبين بوابة الجامعة سوى أسابيع قليلة سرعان ما انقضت ما بين فرحة عارمة وترقب لهيف. وحل أول أيام الدراسة. قلبي يخفق بشدة ، ولكنني لا أعرف طريق الجامعة! وقفت في ميدان العباسية حائرة ، والأمواج البشرية من حولي تأتى وتذهب. أوقفتها ، فتاة محجبة يبدو أنها جامعية أيضاً ، وسألتها:
ـ “لو سمحتي .. جامعة عين شمس بيدخلوها من فين”؟!
وطلبت مني أن أصحبها ، ففعلت. وهكذا دخلت الجامعة ، وبدأت الدراسة. وجوه كثيرة ، كثيرة جداً ، ولكنني لا أعرف منها واحداً. ألمح وجهاً أو وجهين مألوفين ، لعلهما من الحي أو المدرسة. غير أنني أبحث عن وجوه مختلفة ، سمراء اللون ، بيضاء السن ، وذات لهجة سودانية بحتة ، فلا أراها! لربما كانوا في ركن هنا أو هناك ، لكننى لم أجدهم. تعبت قدماي. فتعللت بأنه أول يوم ، ولعلهم لم يأتوا بعد. وضحكت على نفسي ، بل غظتها هامسة لها:
ـ “ما تستعجلي يا برلومة .. غالباً بكره بجوا”!
وجاء الغد ، لكن لم يأت أحد! ومرَّ اليوم (إللى بعدو) ، ثم الأسبوع الذي يليه ، و لا أحد! شهر ، ثم شهران ، وفقدت الأمل. فبدأت أبحث عن نشاطات أنغمس فيها ، وأيضاً لا أجد ما يستهويني! وبدأت فرحة الجامعة تخفت في دواخلي ، وصرت لا أعبأ بها. لا .. لم يكن هذا تصوري للجامعة أبداً! ثم .. أين الشنطة الحمراء؟ من يأتيني بها اليوم من السودان؟! وصرت متيقنة تماماً من أنني لن أجد بجامعة عين شمس نشاطاً يشبع رغبتي ، فقررت أن أبحث عن نشاطات تقام بالجامعات المجاورة ، حتى جاء الفرج!
صديق عزيز أتى ليخبرني عن دورة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تسمى (نموذج جامعة الدول العربية). في ذلك النشاط يصير كل طالبين نواباً عن دولة معينة يدرسان موقفها ، علاقاتها بالدول الأعضاء الأخرى ، أوجه التعاون مع الحكومات المختلفة ، ويتبنون وجهة نظر تلك الدولة في المسائل المعروضة. وسألني الصديق إن كنت أحب المشاركة. ـ “أحب المشاركة؟! إنت بتهظر؟! طبعا أحب المشاركة ، ده البفتش ليهو ذاتو”!
وصرت وإياه ممثلين لجمهورية اليمن الشعبية. ومرت أول أيام واللجان تنعقد. الجميع يحاول تقمص شخصية الدولة التي يمثلها. مندوب ليبيا يرسل إلينا ليخبرنا أنه لن يحضر لأن كل قراراتنا (مطبوخة) حتى قبل أن نجتمع! ويضج الجميع بالضحك. ثم نسعى لإقناعه بالدخول. وتستمر المشاورات والمباحثات. وتسمع من يقول “هذا خيار جيد ومفيد لشعار العروبة والوحدة العربية ، لكنه يضر بمصالحنا”! وأخذنا نعيد الأسطوانة المشروخة بأننا نريد وحدة ، نريد لأوطاننا أن تنجح وأن تستقل.
كنا مدفوعين بحماس الشباب ، وبرغبة حارقة في النجاح. فأقنعنا مندوبي بعض الدول بالتنازل عن المواقف التي تبنتها حكوماتهم ، وذلك من أجل المصلحة العامة. وكان المؤتمر يعقد بجامعة الدول العربية نفسها ، وفي نفس المقاعد التي يجلس عليها مندوبو الدول الفعليون حين ينعقد مجلس الجامعة. وانتهت الجلسات ، وأصدرت لجنتنا قراراتها بالإجماع حول القضايا التي كانت مطروحة أمامنا للنقاش. وكنا اللجنة الوحيدة التي نجحت ، أو هكذا خيل لنا!
أخيراً جاء اليوم الختامي. وفي الاحتفال النهائي الذي تناقش فيه قرارات كل اللجان ، وتوزع شهادات التقدير على المشاركة في النشاط ، إنتظرنا أن يمدح رئيس المؤتمر مجهودنا الجبار الذي حاولنا أن نوحد من خلاله المصير والكلمة! وحضر رئيس الجامعة. شكر الجميع على حضور المؤتمر ، وعلى بحثنا الحثيث ، واهتمامنا بقضايا العالم من حولنا ، والعربي خاصة. لكنه ما لبث أن ألقى قنبلته المُحبطة في وجوهنا:
ـ “إطلعت على تقارير الاجتماعات ، والتوصيات التي خرجت بها كل لجنة ، وهي تعكس مدى وعى الشباب اليوم مقارنة بأوقات سابقة. لكن أيَّما لجنة وصلت لقرارات جماعية تعتبر نفسها فشلت”!
وغصت في مقعدي!
الخميس :
لكم يحبها ، يفتنه جمالها الأخاذ ، يبهره حديثها العذب ، يدهشه حضورها الآسر ، يضطرب كيانه في وجودها! يا إلهى ، كم هي رائعة ، يراها غير كل الناس ، يسرح خلف خيالها ، وهي ، بعدُ ، أمامه ، يمُرُّ على ديارها ، وقد عَفَت الديار ، ديار ليلى! ليلى الشعر ، ليلى الأغنية ، ليلى التي يظل صابراً ينتظر أوان بوحها له ، وحنوها عليه ، وتعطفها بنظرة خاطفة إليه من عليائها .. فهل يطول انتظاره؟!
جلس يرقبها ، صامتاً ، وهي تدخل وتخرج في ثوبها المنزلي الرقيق. يكاد يلتهمها بعين العاشق الولهان ، ولا يكف عن التنهد. أخيراً ، أخيراً جداً ، نظرت إليه ، فانتفض قلبه ، ورقصت مشاعره طرباً. أسبلت عينيها الدعجاوين ، ثم عادت ورفعتهما ثانية ، فكاد لبه يطير! إقتربت منه ، فاختلج صدره بدويِّ طبلٍ بُدائيٍّ عنيف. مدت إليه وردة يانعة ، فعجب كيف أنه ما زال في كامل وعيه! رأى شفتيها تتحركان ، تهمسان ، لم يتبيَّن ، للوهلة الأولى ، ما قالت. حاول أن يركز أكثر حتى لا تضيع منه ثانية واحدة من تلك اللحظات الغالية. سمعها هذه المرة جيداً. كانت تسأله بحدة ، ويدها ممدودة إليه بإناء معدني فارغ:
ـ “جبت اللبن”؟!
هز رأسه كمن أفاق للتو من حلم لذيذ. ثم أجابها ، وهو يخطف إناء اللبن من يدها ويركض صوب الباب:
ـ “لا لسة ، حسة حأمشى أجيبو”!
الجمعة :
الثالثة صباحاً. أولى لحظات عناقي لأرض الوطن بعد غياب طويل. المصابيح الشاحبة تزداد شحوباً. النعاس يطير أبخرة مع حركة الأقدام تبحث عن الأحذية المبعثرة تحت المقاعد. صوت المضيفة تبلغنا ، وكأنها تتلو شعراً ، بقرب الهبوط في مطار الخرطوم ، وتطالبنا ، كما لو كانت تغني ، بربط الأحزمة وإعادة الكراسي إلى أوضاع الاستقامة. إطارات طائرة الخطوط الكينية تلثم أرض المطار بسلاسة. أرقب الركاب من حولي ينهضون ، ينزلون حقائبهم الخفيفة من الأرفف ، ويتزاحمون في صفوف طويلة انتظاراً لفتح الباب إيذاناً بالنزول. ما زلت قابعة بمقعدي ، أحتضن طفليَّ ، وأنا أرسف ما بين توق نابح وخوف خفي! ترجل الركاب أجمعين. أخيراً أحكمت وضع حقيبتى على ظهري. وحملت أحد الصغيرين بيد ، وأمسكت الآخر بالأخرى. رددت تحية المضيفة الجميلة ، ثم اجتزت باب الطائرة إلى سلم النزول ، وعيناي تجولان حول المكان.
دلفت إلى صالة المطار. ملأت البيانات. أمسك الموظف جوازي. أمعن التحديق فيه وفي ورقة البيانات ، ثم قال:
ـ “نسيتي تملي أهم خانة يا غادة عبد العزيز خالد”!
لم أدرك مقصده. لكنه أردف دون أن ينتظر ردي:
ـ “خانة الاسم”!
رددت عليه بصوت خفيض ، وهو يمسك بالقلم ليملأ خانة الاسم نيابة عنى. لا أذكر ماذا قلت. لعلى نسيت ، أو اضطربت. ناولني الجواز ، فواصلت مسيري مع الطفلين.
وقفت أمام السير أنتظر حقائبي ، وإحساس غريب بالخوف يعتريني! نعم الخوف! فبعد غياب عن السودان دام لأكثر من خمسة عشر عاماً قضيتها ما بين مصر وأمريكا ، ظننت أنني سأصيح من الفرح ، سأرقص على أعتاب الوطن طرباً ، وسأقبل التراب شوقا ولهفة. لكن ، بدلاً من كل ذلك ، ها أنذا أقف هكذا .. وجلة ومرتبكة!
إلتقطت حقائبي من السير. وضعتها على الحامل المتحرك ، ورحت أدفعه أمامي ، وأنا أعبر الصالة إلى باب الخروج. فجأة ، سمعت صوتاً أليفاً يهتف باسمى. رفعت عينيَّ نحو مصدر الصوت على الشرفة الداخلية ، لأرى وجه شقيقتي الصبوح ، ويدها تلوح بشوق. بادلتها التلويح والابتسامة العريضة. في الباحة الخارجية وجدت أبى في الإنتظار ، وبرفقته عمى وابنة عمى. أحقاً هذه هي؟! فارقت السودان قبل أن تولد حتى ، وها هي اليوم شابة جميلة يانعة. ركبت العربة وطفلاي ، هاشم وشهاب ، ينظران حولهما في حيرة.
ـ “ماما إحنا وين”؟!
ـ “وصلنا السودان”.
إنتابت هاشم فرحة غامرة ، فقد دأبت على الاكثار من ذكر (السودان) في الفترة الأخيرة ، وصرت أذكر لهم أين سنذهب ومن سنقابل. لكنني ، وأصدقكم القول ، لم أجرؤ أن أقول لهم كلمة واحدة عن دارفور ، أو عن كيف تركنا أطفالها يعيشون على الاغاثات في الملاجئ والمخيمات! أخجل أن أقول لهم هذا ، فأنا لا أريدهم أن يكرهوني أو يكرهوا وطنهم! وهكذا صار هاشم يسأل عن (السودان) في كل لحظة ، حتى أنه حين سمع المضيفة تعلن ، بعد دهر من الطيران ، عن قرب وصولنا مطار (أمستردام) ، هتف فرحاً ظاناً أننا وصلنا (السودان)! وحاولت (عبثا) أن أشرح له أننا لم نصل (السودان) بعد ، وإن كنا عبرنا الأطلنطي ، ودخلنا أوربا ، فأصبحنا قاب قوسين أو أدنى منه!
و .. أخيراً ، ها أنذا في البيت الذي احتضن طفولتي وصباي الباكر. لم أنسه للحظة. كانت خارطته ملء ذاكرتي. تهتك قليلاً ، بعض شروخ على الجدران ، والأثاث الذي ظل بداخله قرابة السبعة عشر عاماً صار قديماً وحال لونه بعض الشئ ، لكنه لا يزال جميلاً كما هو. نمت ليلتها قريرة العين. وفي الصباح خرجت أتجول في شوارع الحلفاية. أذكر المنازل. لم تتغير. الزمان هو الذي تغير! بعض سكانها فارقوها ، وسكن الأخريات آخرون.
مرَّ الأسبوع الأول ، لكن حركتي ما زالت محدودة لم تتعد مدينة بحري. والجميع يسألون:
ـ “أها .. لقيتى السودان كيف”؟!
ـ “و الله يا هو زاتو .. أصلو ما اتغير”!
ـ “كيف ما اتغير؟! هو إحنا حاسين بفرق”!
ـ “غايتو أنا ماشفت غير الحلفاية وسعد قشرة .. و الاثنين ما اتغيروا”!
ومرت أسابيع أخرى. و بدأت أتجول حول العاصمة المثلثة ، الخرطوم وبحري وأم درمان. ثمة طرقات لم ترصف بعد ، وإن كانت ثمة بعض الطرق والجسور الجديدة. لكن الفقر ما يزال سيد الأمكنة. أما الإنسان فما يزال ، برغم كل شئ ، بسيطاً و طيباً. غير أن أكثر ما لفت نظري كثرة المنازل الجميلة العالية والشاهقة. أعلم أن الكثير من المغتربين قد عادوا ليستقروا ومعهم مدخرات أعوام شاقة طويلة ، وأن كثيراً من الشرفاء قد كدوا وتعبوا. ولكن نسبة عمار البنايات يمثل بالنسبة إلىّ الفردية والمنفعة التي طالت البعض على حساب الآخرين ، بينما المصالح العامة والمرافق التي من المفترض أن ينتفع بها الجميع لم تنم و لم تزدهر. ولا زلت حتى الآن أحاول أن أقيّم ، هل هذا عمران حقيقي من النوع الذي عناه عالم الاجتماع العربي عبد الرحمن بن خلدون ، أم مجرد تطاول رعاة شاة في البنيان؟
السبت :
كانت إقامتي بمصر هي أولى تجاربي في الاحتكاك بالأخوة العرب. قبلها لم أكن أفكر كثيراً في الكيفية التي ينظر بها الآخرون إلينا كسودانيين. ولم أكن أعطي تلك المسألة أي اعتبار ، حتى جئنا وعشنا هنا.
بدأت ألحظ أن ما يعتبره المصريون مجرد دعابة يتفكهون بها ، نأخذه نحن على محمل الجد ، والجد خالص .. بل وقد “نضارب” حوله! ذات يوم ذهبت وأمي إلى السوق. سألت أمي البائع عن سعر قطعة من القماش. تفاصلا في السعر:
ـ “والله يا ستى ما ينفعش ، خلاص يا مدام خديه ببلاش”!
ـ “لا ما باخدوش ببلاش ، لو ينفع إديهولى ولو ما ينفعش يفتح الله”!
فالتفت البائع إلى زميله قائلاً له:
ـ “ياااااااه! دي حمقا زى حماتي”!
فاشتعلنا غضباً في التو والحين ، حتى اضطر البائع وزميله وحتى زبائن المحل للاعتذار لنا بشدة! لكن ، بمرور الأيام ، بدأنا نتعود على طريقتهم في الحوار والنقاش والمفاصلة.
والتقيت ، بعد إخوتنا المصريين ، بإخوة وأخوات من السعودية ولبنان والمغرب. كل ما يعرفونه عن السودانيين أن دمهم حار جدا! أخبرني أحد الإخوة السعوديين عن زميل لهم بالشركة يتعامل مع سوداني بفرع للشركة في مدينة أخرى تبعد عن مدينتهم بحوالي ساعتين. وفي مكالمة تلفونية احتد الزميل السعودي مع السوداني ، وقال له:
ـ “روح يا حيوان”!
فما كان من السوداني إلا أن صرخ فيه:
ـ “حيوان أنا؟! طيييييييب .. أبقى راجل واستنانى أنا جاييك حسه دي”!
ووضع الزميل السعودي السماعة بهدؤ ، ظنا منه أن الأمر انتهى عند ذلك الحد. لكن ، ما كادت تنقضي ساعتان أو أقل ، حتى دخل عليهم ذلك السوداني كما الاعصار ، وهو يرغي ويزبد والشرر يتطاير من عينيه ، والدم يغلي في عروقه من الغضب:
ـ “أنا؟! أنا تقول لي حيوان”؟!
ولم تنته الأزمة إلا باعتذار الزميل السعودي ، وتدخل زملاء المكتب ، وتقبيلهم لرأس أخينا السوداني!
وبالرغم من هذا (النفس الحار) لدى السودانيين ، إلا أنني أعتقد أن الشعب السوداني ساخر بطبيعته. قيل إن إحدى المحطات الفضائية استضافت ، ذات مرة ، إبن الثري السعودي المعروف الوليد بن طلال وإسمه (خالد). سأله المذيع عن موقف طريف مر به ولا ينساه. فقال إنه ، وفي يوم شديد الحرارة ، كان يستقل سيارته مع سائقه ، فرأى رجلاً يمشى على رجليه تحت وهج الشمس ، والعرق يتصبب منه بغزارة. فطلب من السائق أن يتوقف ، وسأل الرجل عن وجهته. فاكتشف أنه كان ما يزال بعيداً جداً عنها. فأركبه معه ليوصله. وفى الطريق عرف أن الرجل سوداني ، فتحدث معه عن طبيعة عمله وبعض أخباره. فسأله السوداني:
ـ “يعنى ما اتعارفنا يا أخ”.
فأجاب الأمير بعفوية:
ـ “أنا الأمير خالد بن الوليد”!
فما كان من السوداني إلا أن رد على الفور:
ـ “لا ياشيخ! وأنا الخليفة عمر بن الخطاب”!
وعندما تقدم زوجي معز لخطبتي ، سأله أصدقاؤه ، وهو في الطريق لمقابلة والدي ، إن كان مستعدا لملاقاة (أبو النسب) فأجابهم بالإيجاب. فقال له أحد الأصدقاء:
ـ “يا زول هه ، إنتا قايلو حيسألك شغال وين وبتصرف كم؟! ده أسئلتو حتكون كلها من نوع إنت بتعرف تضرب كلاشنكوف؟! بتعرف أنواع المسدسات والطلقات”!
ومما يدل على حب السودانيين للدعابة تذوقهم للكتابات الساخرة ، كمقالات عبد اللطيف البونى وسعد الدين إبراهيم والفاتح جبرا ، بل وحتى عادل الباز مؤخراً! وكذلك إقبالهم على شرائط النكات التي راجت خلال السنوات الماضية رواجا كبيراً على يد فرقة الهيلاهوب. ومن حب الناس لهذه الفرقة لم يقتصر نشاطها على الشرائط ، بل صارت تلبي الدعوات وتشارك في حفلات المناسبات المختلفة. ويبقى السؤال المشروع: لماذا ، مع كل هذا ، عٌرف السوداني (بالنفس الحار)؟!
الأحد :
يقول جوردون توماس: “إن العلاقة بين العمل المخابراتي والجنس قديمة قدم الجاسوسية نفسها ، ففي كتاب يشوع التوراة ورد أن الزانية “راحاب” أنقذت حياة اثنين من جواسيس يشوع من بطش رجال ملك أريما. وهذا أول ارتباط أزلي مسجل بين أقدم مهنتين عرفتهما البشرية” (التاريخ السري للموساد ، ص 184).
ولسبب ما تستهويني دوماً قصص الجاسوسية. وفي صغري شغفت بروايات أدهم صبري ، رجل المخابرات المصري خارق القوة ، والذي يستطيع عمل كل شيء. يغير ، بين اللحظة والأخرى ، من منظره و هندامه! يكون أمامك ، ثم يختفي في ثانية فلا تراه! رجل المهام المستحيلة الذي (دوخ) سونيا ، عميلة الموساد الإسرائيلية التي حاولت الإيقاع به بشتى السبل ، لكن مهمتها كانت تنتهي بالفشل في كل مرة. كما شغفت أيضاً بمشاهدة أفلام جيمس بوند ، عميل المخابرات البريطاني وسيم المحيا ، قوي البنيان ، حاد الذكاء ، سريع البديهة والتصرف!
جوردون توماس صحفي يهودي إسرائيلي كتب حوالي سبعة وثلاثين كتاباً يدور أغلبها حول الجاسوسية وأنشطة المخابرات. ترجم الكتاب إلى العربية وقدم له الصحفي المصري عادل حمودة محذراً من تصديق القصص الخيالية التي أوردها جوردون ، قائلاً إن معظمها لا يمكن التحري من صدقه! إحدى هذه القصص ، على سبيل المثال ، كانت عن دور الموساد في مقتل الأميرة ديانا وصديقها العربي دودى الفايد ، وكيف أن سائق سيارة الأميرة كان عميلاً للمخابرات الإسرائيلية! كذلك تطرق جوردون في كتابه إلى عملية ترحيل الفلاشا ، وإلى المفاوضات التي أجرتها الموساد مع بعض ضباط أمن النميري. وقال إنهم سألوا أحدهم تقديم يد العون لهم في بعض مهامهم على أن يطلب منهم ما يريد ، فطلب دراجة بخارية يبدو أن “نفيستو كانت فيها”! وروى جوردون كيف أن الطلب الغريب أوقع مسئولي تل أبيب في حيرة ، وهم يحاولون ، عبثاً ، الوقوف على المعنى الحقيقي لطلب رجل الأمن ، حتى لقد ظنوا ، في البداية ، أنه يريد ذهباً يزن دراجة بخارية ، ولكنهم ما لبثوا أن تحققوا من أنه بالفعل لا يبغي غير .. دراجة بخارية!
أكثر ما يلفت نظري في قصص الجاسوسية هو المرأة ، وطريقة التعبير عنها ، والصورة التي يبرزونها بها. فعميلات الموساد دوماً فائقات الجمال ، يسرن في ضوء خطط مدروسة يلعب جمالهن أهم الأدوار فيها. وقد اطلعت ، في إحدى القصص المنشورة على الشبكة الإليكترونية ، على محاولة إحدى عميلات الموساد الإيقاع بضابط عراقي. وقد وصف الكاتب كيف “اقتربت منه سيدة فائقة الجمال ، تنزلق من عينيها الدموع السخية”! فها هي المرأة توصف هنا بمتلازمتي الجمال والضعف .. ويا لهما معاً من سلاح فاتك! وفى قصة أخرى عن آمنة داود المفتى ، الأردنية التي عملت جاسوسة لصالح إسرائيل ، يصفها الكاتب بأنها “في المرحلة الثانوية أوغلت فيها مظاهر الأنوثة ، فبدت رقيقة الملامح ، عذبة ، شهية ، طموحة ، ذكية” ، لكنه لا ينسى أن يضيف أوصافاً أخرى (كالحية الناعمة الملمس) ، مثلاً ، أو (العميلة المخلصة التي تعرف لغة الجسد) ، أو (العميلة القادرة على جعل أكثر الرجال صلابة يتعشقها ويذوب فيها) .. الخ.
ورغم حبى الشديد لقصص الجاسوسية ، إلا أن طريقة التعبير عن المرأة فيها تبدو لي دائماً مبتذلة. فهي لا تقوم ، في معظم الأحيان ، بغير الدور الرخيص المنوط بها أن تستخدم فيه جمال جسدها وملامحها. ومع أن الوضع الاجتماعي للمرأة في كل المجتمعات تقريباً آخذ في التغير نحو الأفضل خلال السنوات الماضية ، إلا أنه تغير نسبي طفيف في ظني ، فما يزال أمام النساء الكثير من المهام النضالية التي ينبغي عليهن إنجازها في سبيل نيلهن لحريتهن وحقوقهن كاملة ، وعلى رأسها الانعتاق من تلك الأدوار التقليدية التي التصقت بهن تاريخياً.
لكن ، مع ذلك ، لا أظننى أستطيع التوقف عن قراءة قصص الجاسوسية التي أجدني مستغرقة فيها بكل جوارحي!
الإثنين :
كثيرا ما تلفت (الإعلانات) نظري و تحوز على اهتمامي. أذكر أنني عندما كنت صغيرة ، وقبل خروجنا من السودان ، كانت ثمة إعلانات لصنف من الحلويات. وحتى الآن ، ورغم طول المدة ، إلا أنني ليس نادراً ما (أظبط) نفسي أغني مقاطع من ذلك الإعلان:
ـ “حلاوة حلا. أول إنتاج كان في السودان لحلويات أشكال و ألوان ، حلاوة حلا”!
وعلى أيامنا بالقاهرة ، كنت أيضاً كثيراً ما أهتم بالإعلان ، فـ (دم) إعلاناتهم ، في غالبه ، خفيف! في إحدى المرات رأينا ، أنا وشقيقتي ، إعلاناً لحبوب مص. وما أن تضع فتاة الإعلان حبة منها في فمها ، حتى يتطاير شعرها الطويل ، ويمص الفتي ذات الحبوب ، فيقف شعره (قرون قرون)! نظرت أنا و أختي إلى بعضنا البعض وركضنا سريعاً نحو (الكشك) أسفل العمارة ، فابتعنا بالنقود القليلة التي كنا نملكها تلك الحبوب ، وأخذنا نمصها. لكن ، يا للأسف ، طعمها سيئ للغاية! قلت لشقيقتي ، تعبيراً عن خيبة أملي:
ـ “كنت قايلاها حتكون حلوة”!
ـ “وأنا برضو”!
ومرت فترة ، والطعم لا يزال غير مستساغ. ثم سألت شقيقتي:
ـ “أها .. شعري وقف”؟!
فتجيبني بالنفي. و تصمت قليلا ثم تسألني هي نفس السؤال ، فأجيبها أيضا بالنفي. حتى يئسنا و(قنعنا) ، فلفظت كل منا باقي الحبة من فمها ، ونفوسنا ساخطة على تلك الحبوب.
و أذكر أن حضر والد أحد الإخوة السودانيين من السودان إلى القاهرة بغرض العلاج ، وكان ذائعاً وقتها إعلان صابون غسيل معين ، وكان (ماكل الجو)! نجمة الإعلان ، الممثلة المصرية (نرمين الفقي) كانت وجهاً جديداً وغير معروف آنذاك ، وكان ذلك الإعلان سبباً في شهرتها ، حيث أحبها الناس سريعاً ، بوجهها الجميل ، وحضورها الطاغي على الشاشة. وذات يوم ، وبعد أداء والد السوداني لصلاة العشاء ، وبينما هو لا يزال على سجادته ، سأل ابنه ، و بكل جدية:
ـ “إنت دعاية الصابون ديك الليله ليه ما جابوها يا ولدي”؟!
و كثيرأً ما كان يدور النقاش بيننا حول جدوى الإعلانات ، وهي غالباً ما تكون باهظة التكلفة. وكنت أعتقد أن للإعلان أثر إيجابيّ في ترويج السلعة ، بينما كان البعض يرى أنه من (العبط) أن يقوم أحدهم بشراء سلعة ما فقط بسبب رؤية إعلان عنها! وكنت ، وما زلت ، عندما أقع في حيرة من أمري حول أي منتج أشتري ، أذكر بسرعة الإعلانات التي شاهدتها عنهم ، و أبتاع الذي أقنعني إعلانه. و بعد ذاك يمكن أن أقرر. وكنت استرجع دائماً قصتي وأختي مع تلك الحبوب ، وأقول إن للإعلان أثر قويّ علي المستهلك. فحتى اليوم , عندما أذكر تلك الحبوب أقول:
ـ “أعوذ بالله ، الله لا كسبها”!